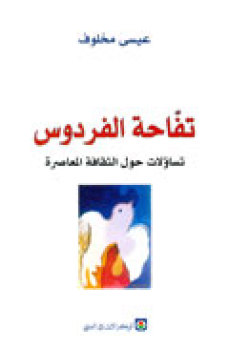تمهيد
II
يتغيّر العالم ومعه يتغيّر المعنى الثقافي، ولا تتغيّر عندنا طبيعة المقولات والسجالات التي تطالعنا منذ قرابة النصف قرن. وتبقى الأسئلة الأولية مطروحة: هل نعيش في حاضر العالم اليوم؟ هل توجد دولنا وأوطاننا على خريطة العلوم والمعرفة؟ أين هي المضامين الفكرية لمفاهيم الحداثة وأين الإشكاليات الفكرية عندنا، وهل أنتجنا فكراً يساعدنا في فهم الواقع الراهن؟
كان الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر محطة في التاريخ، مثل السادس من آب 1945 يوم ألقيت القنبلة النووية فوق هيروشيما، لكنّ الحادي عشر من أيلول لم يأتِ من فراغ، وهو غير منفصل عن سياق تاريخي متكامل أوصل العالم إلى ما هو عليه. هناك سياسة محدّدة مهّدت لهذا التاريخ. وهي لا تزال، حتى الآن، تعمل على التحضير لتواريخ مظلمة مماثلة. بل يمكن القول إن هذه السياسة، إذا ما استمرّت على حالها، قادرة على ابتكار تواريخ أشدّ رعباً وفتكاً. لقد ظنّت بعض السياسات أن استعمال الدين من أجل غايات سياسية أو مصلحية مادية، مسألة يمكن ضبطها بجهاز التحكم عن بُعد، وفات اللاعبين بمصير البشرية أنّ هذا المركَّب العجيب: التشدّد الديني وامتلاك الأسلحة المتطوّرة والانفتاح على التكنولوجيا الحديثة، من شأنه أن يولّد قوّة لم تكن معروفة في العالم، بهذه الحدّة، قبل الآن.
إن الحرب التي تُشنّ على "الإرهاب"، بنزعتها الانتقامية وخطابها المتطرّف، تبدو كأنها الوجه الآخر لما تعمل على محاربته. وما معنى هذه المواجهة أيضاً حين نحارب الإرهاب هنا، ونغضّ الطرف عن الإرهاب هناك، فتصبح الحرب المعلَنَة ضدّ الإرهاب واجهة تخفي حرباً أخرى.
حيال هذا الواقع، كيف يواجه العالم العربي الذي يتمتع بثروة نفطية هائلة ويشكل موقعاً استراتيجياً شديد الأهمية، التغيّرات والتحديات القائمة؟ كيف ينظر إلى القوى العسكرية العظمى المتمثلة اليوم في الولايات المتحدة الأميركية، فالقوى الاقتصادية الصاعدة المتمثلة في اليابان والصين؟ هل من تصوّر واضح للعلاقة مع إسرائيل وما طبيعة هذه العلاقة؟ هل استطاعت الثقافة العربية، بما تنوء تحته من هموم ومشكلات وتناقضات، أن تستوعب أحداث الحادي عشر من أيلول / سبتمبر وتداعياتها؟ كيف لهذه الثقافة أن تستوعب ما يجري حالياً وهي لم تستوعب الحروب والهزائم التي لحقت بنا منذ الأربعينات من القرن الماضي حتى اليوم، ولم تبحث فعلياً عن الأسباب التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه؟ وقبل ذلك، أين نحن من بعض الأسئلة التي سبق أن طرحها الإصلاحيون، نهاية القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين، وثمة أسئلة، بل وأجوبة مطروحة اليوم، مع نموّ المدّ الأصولي، تعيد العالم العربي إلى مراحل ما قبل التاريخ، وتكشف عن ذهنيّة لا تنقضّ فقط على ما هو مغاير ومتميّز في الحاضر، وإنّما أيضاً على الجزء الحيّ من الحضارة العربيّة نفسها.
ليس جديداً القول إن إهمال الموروث العقلاني في الحضارة العربية والإسلامية لا يبدأ مع التيارات الأصولية المنحازة إلى الفكر الغيبي المتطرّف الذي لا يقبل بالاختلاف، بل مع الأنظمة التي لم تعمل منذ نيل استقلالاتها الوطنية حتى اليوم على وضع نظم تربوية وتعليمية عصرية، وعلى بناء مؤسسات المجتمع المدني بالمعنى الحقيقي لهذه الكلمة، من أجل مواجهة الثقافة التقليدية والدخول في العصر. وهذا من الأسباب التي مهّدت للاجتياح الأصولي القائم، وسهّلت في بعض الدول العربية اختراق المتشدّدين لأجهزة الإعلام والتعليم والنقابات والجامعات ووصولهم إلى النشء الجديد.
نعم، الغرب السياسي يريد للعالم العربي أن يبقى خارج العصر، أو داخله، لكن بما يتناسب مع شروطه ومصالحه، أمّا العالم العربي فهو أيضاً يسعى، بجدّ واجتهاد لا مثيل لهما، إلى تحقيق تلك الأمنية.
II
إثنان يحكمان العالم الآن: التكنولوجيا والاستهلاك. في ظلهما تتحرّك سياسة الدول الكبرى والبنك الدولي واقتصاد المعرفة والزراعة المعدَّلة وراثياً والمنظومات الآلية والمعلوماتية وثورة الاتصال وما يمكن أن تغيِّره في طريقة الرؤية والتفكير، والنظرة إلى البيئة والثقافة والمجتمع. وكلّها يتمحور حول المردودية المادية التي أصبحت قوام الهيمنة والتفوق والاستئثار على المستوى العالمي العامّ. وهذا المنطق لا يعنيه من العالم سوى التحكم بالعالم حتى لو أصبح أنقاضاً.
لقد ظنّ الغرب أن نهاية الحرب الباردة هي نهاية لتاريخ وبداية لتاريخ آخر يتمثّل في الرأسمالية المنتصرة. وفات المنتصرين أن إقصاء قسم من البشرية على حساب القسم الآخر لا يمكن أن يولّد إلاّ مزيداً من الحروب والأهوال والعنف. وثمة هوّة تزداد اتساعاً بين التقدم العلمي والتكنولوجي من جهة، والنزعة الإنسانية من جهة ثانية. أمّا الثقافة فتنحو في اتجاهات جديدة وتتحوّل، أكثر فأكثر، مادّة للتسلية. ومع ذلك، يبقى السؤال مطروحاً: هل يستطيع المفكرون والفنّانون والأدباء أن يغمضوا أعينهم عمّا يجري حولهم، خصوصاً على المستويين العلمي والتقني؟
منذ القديم نظر الإنسان إلى السماء. لقد جرى غزو الفضاء في مخيّلة الشعراء والأدباء والرؤيويين قبل وقت طويل من حدوثه تقنياً. كان ثمّة حاجة دائماً إلى الارتقاء وبلوغ المستحيل. منذ العصور القديمة حتّى عصر النهضة الإيطالية. من إيكار في الأسطورة اليونانيّة إلى سماء دانتي في "الكوميديا الإلهيّة"، ومن رؤيا يوحنّا الإنجيلي إلى الرؤيويين الألمان، ومن الإسراء والمعراج إلى إبن عربي وعمر الخيّام، كان اختراق السماء عبر الأسطورة والدين والشعر محاولة لاختراق الأسرار الكبرى. إلاّ أن شكل التعبير عن هذا الاختراق تبدّل بين عصر وآخر وذلك وفقاً للمعطيات المعرفية المتعلّقة بالسماء في كلّ زمن. زمن التحوّلات الأولى أوّلاً، ثمّ من القرون الوسطى إلى عصر الأنوار، ومن القرن التاسع عشر حتّى يومنا هذا بعدما أصبحت أسئلة الكون والفلك مهمّة الفيزيائيين وعلماء الفلك أكثر منها مهمّة الشعراء. هكذا فإن الثورة العلميّة والمعرفيّة لا بدّ أن تفتح أمام الحلم آفاقاً جديدة غير معروفة من قبل، ويأخذ التعبير عنها أشكالاً جديدة.
نحن نعيش في عالم متغيِّر. وأظنّ أن اللغة القديمة ما عاد في إمكانها أن تقول العالم الجديد الذي نعيشه.
كيف نكتب الشعر والنثر وكيف نمارس جميع أنواع الفنون التي يلعب فيها الحدس الإبداعي دوراً مهماً بدون الالتفات إلى ما فعله ويفعله التلفزيون والإنترنت، وبدون التنبّه إلى بعض الإنجازات العلميّة الباهرة؟ لا أتوقّف هنا عند كيفيّة استعمال هذه الإنجازات، وتوظيفها في الحرب أو في السلم، بل أشير إلى قدرتها على الكشف وعلى تجسيد بعض الرؤى وإعطاء الحدس شكلاً.
مع التطوّر العلمي وُلدت نظرة جديدة إلى العالم، فهل أخذنا في الاعتبار التطوّر التقني والتكنولوجي ومنجزاته وأثره في مجالات الإبداع المختلفة؟ رامبو تحدّث عن ألوان الأحرف. الآلة تظهر لنا اليوم شكل هذه الأحرف وشكل الذبذبات الصوتية، وتقترب من منطق الطير وسلوكه، بل تذهب أبعد من ذلك وتجعلنا نرى ولادة النجوم وموتها. وتُدخلنا إلى طبيعة الخلايا والجينات، وتعرف ما في داخل الأرحام، قبل الوضع...
أمام الكشوف العلميّة إذاً، وأمام التحوّلات التي يعيشها عصرنا على جميع المستويات، ألا ينبغي أن نطرح السؤال مجدّداً على نظرتنا إلى الإبداع وعلى أساليبنا وأدواتنا التعبيريّة، وفي مقدّمتها اللغة. هذه اللغة التي تحتاج منّا إلى إعادة نظر كاملة وتحتاج إلى تطويع كامل لتكون قادرة على نقل حركة وجودنا، فكراً وخيالاً وجسداً.
III
يتضاعف النزوع نحو الاستبداد والاستئثار لدى الدول العظمى، وفي المقابل يتزايد التحجّر والانغلاق في المجتمعات العربية والإسلامية مما يعمّق الإحساس بالمنفى، وكلمة منفى هنا لا تنحصر فقط في معناها الجغرافي بل تتجاوزه أيضاً لتتّخذ المعنى الذي حدّده الفيلسوف الفرنسي سارتر بقوله إن المنفى هو حين يضيِّع الإنسان مكانه في العالم.
ويبقى السؤال: ماذا تُعدّ هذه المجتمعات لنفسها من أجل مواجهة التحديات الكبرى المتعاظمة ومن أجل بلوغ حوار متكافئ مع الثقافات الأخرى؟ طبعاً ليس الموروث السلفي ولا تقديس الأجداد ما نحتاج إليه الآن. وإذا كان لا بدّ من الالتفات إلى الماضي فليكن إلى جوانبه المضيئة، العقلانية والجمالية فحسب، أي إلى الماضي الذي ينظر إلى المستقبل، لا الماضي المحنَّط والمنغلق على نفسه كالقبر.
نحتاج الآن إلى ولادة أخرى، إلى أبوين آخرَين بعيداً من ذهنية التكفير والتخوين.
نحتاج إلى شجرة لا تخفي بين أغصانها تفاحة، وتفاحة لا تخفي بذور الخديعة والشرّ والموت!
نحتاج إلى حواء قادرة أن تقول بدون رهبة أو تردّد: بيدَيّ الاثنتَين أطعمك التفاحة ولا خوف عليك.
لا خوف من شجرة المعرفة، على الأرض كانت أو في السماء.
تحرير الإنسان من الخوف، كتحريره من الجهل، بدايةُ التخلّص من العنف.
بداية لإنسانية جديدة.
IV
يحتوي هذا الكتاب على جزء من الدراسات والمحاضرات والمداخلات التي كُتبت على مدى سنوات طويلة، لا سيّما السنوات الأخيرة، وينقسم إلى ثلاثة أقسام أساسية: القسم الأول يُعنى بتغيّر المعنى الثقافي في العالم وينطلق من تساؤلات تطول الثقافة بعامّة، والثقافة العربية بخاصّة. القسم الثاني يتناول تجارب بعض أعلام الثقافة، شرقاً وغرباً، كما يتناول ظواهر ثقافية وفنية مختلفة. أما القسم الثالث والأخير فيلتفت إلى ملامح من الأدب والثقافة في القارة الأميركية اللاتينية، ومن ضمنها الملمح العربي البعيد.
باريس 21 كانون الثاني / يناير 2006
عيسى مخلوف